|
أرسل لي الشاعر الحروفي الأستاذ
أديب كمال الدين مشكوراً من
أستراليا نسخة من المجلّد الثالث
من أعماله الشعرية الكاملة الصادر
حديثا ببروت عن منشورات ضفاف،
علماً بأنني أتابع بشوق ما ينشره
من قصيد إضافة إلى ما يكتبه
النقاد عنه. أديب كمال الدين
الشاعر الذي يحاول أن يشحن الحرف
بالطاقة إلى درجة أننا نجده يُضفي
فيه على الكلمة أو على الجملة
الشعرية اعماقاً ورؤى يمنح فيها
الحرف ترميزا كبيرا ودلالات أكبر
عن طريق اختزاله للّغة. ولا
أتجاوز إذا قلت إنه يختزل المعنى
المعجمي للحرف في ومضات متتالية
عفوية تنساب من اللاوعي وفقاً
لمعطيات الوجد الصوفي الذي يحمله
تجاه الحرف المشحون بالطاقة ليصل
به إلى مرحلة (الكشف الروحي) بغية
الوصول إلى ماهيّته!
واذا كان الكثير من الصوفيين
يضفون على الحرف روحا معينة
ويضعون له رياضات روحية خاصة به،
كما يضعون له رقما خاصا به يأتي
اشبه بكلمة السر، كما يضعونه في
اشكال هندسية على شكل مثلثات أو
مربعات أو مخمسات وهكذا، بحيث
يأتي مجموع الأرقام متساوقا مع
قيمة تلك الحروف، وضمن عدد معين
ليمثل آية قرانية أو اسما من
أسماء الله الحسنى أو حتى لحروف
ٍلها دلالاتها وأسرارها الخاصة،
بحيث يكون المجموع واحدا من أيّ
اتجاه نظرت اليها في ذلك الشكل
الهندسي عموديا كان أم أفقيا من
اليمين إلى الشمال أو من الاسفل
إلى الاعلى.
فلو أخذنا مثلا الوفق
المثلث الخاص ب (أبو حامد
الغزالي) لوجدنا أن مجموع الحروف
فيه يكون 15 كنظير لترتيب الحروف
التي يضعها الروحاني الغزالي في
مثلثه، ففي الحقل الأعلى يضع
الحروف (ب،ط،د) وفي الحقل الأوسط
يضع (ز،ه،ج) أما في الحقل فيضع
الحروف (و،ا،ح))
ويضع الأرقام المقابلة لها بالشكل
التالي ليضعها حسب الخانات التسع
(
في الأعلى :2+9+4 وفي الوسط 7+5+3
اما في الترتيب الثالث فتكون
6+1+8
ولو جمعناها بايّ اتجاه لكان
المجموع واحدا ألا وهو الرقم 15
واذا كان كتاب الله المجيد يفتتح
سوره ببعض من الحروف ليعطيها معنى
خاصا وإعجازا حقيقيا: (ألم، ألمص،
ألر، ألمر، كهيعص، طه، طس، حم
عسق، يس، ص، حم، ق، ن) التي تحمل
دلالات يعجز المفسرون من الوصول
إلى أسرارها الكليّة، والسر عند
الصوفيين يجب الاحتفاظ به وعدم
الاباحة به. وعلى حد تعبير
الحلاج:
(لأنوار ِنورُ النورِ في
الخلق أنوارُ
وللسرّ في سرّ المُسرّين
أسرارُ!)
ويذهب بعض المفسرين إلى أن حرف
(القاف) يمثل تصاعداً رقمياً مرة
يأتي على شكل متوالية عددية، ومرة
أخرى على شكل متوالية هندسية كما
وردت في (سورة ق)، كما يذهب إلى
ذلك الدكتور مصطفى محمود. ولو
نظرنا إلى حرف التاء في الآية 85
من سورة يوسف (قَالُوا
تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ
يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا
أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ)
لرأينا أن الكلمات الثلاث تبدأ
بحرف التاء مما يعطيها دفعا خاصا
لدى النقاد ألا وهو ذلك الإيقاع
الخاص الذي يشكّله وبما يطلق عليه
(الجناس) في علم البلاغة، ومثل
ذلك يظهر جليا لدى الشاعر (امرؤ
القيس) في بيته الشعري الشهير:
(مكّرٍ مفّرٍ مقبلٍ مدبرٍ
معا
كجلمود صخر حطّه السيلُ من علِ!)
حيث يظهر لنا ذلك الإيقاع
الخاص في حرف المصدر في بداية
الكلمات الخمس الأولى ألا وهو حرف
الميم، إضافة إلى ما نجده في
الإيقاع المتضاد في الحركة!
ومن هذه المقدمة نجد أن السؤال
الذي يطرح نفسه هو: هل كان الشاعر
أديب كمال الدين الذي تُرجم شعره
إلى سبع ٍمن اللغات يتبع هذه
السياقات الحروفية التي وضعها
الصوفيون ام أنه جاء على غير ذلك
النهج! وعن مثل ذلك تحدّث الشاعر
عن (النقطة) وألهمها سرّاً مضمراً
يختلف عن باقي الحروف؟ وإلى مثل
هذا يذهب الناقد الدكتور حسن ناظم
(جريدة
الصباح البغدادية 17 حزيران 2015)
ليقول: (إنَّ شعر أديب كمال الدين
يقف ضدّ الحسيَّة التي تضرب بجذور
عميقة في عالم الشعر؛ ليس فقط
لأنَّ داعي الروحانيَّة ذو أثر
بيِّن في شعريَّته، بل لأنَّ
الحسيَّة لم تُسعفْه أداةً في
الإيفاء بخلق عالمٍ روحانيٍّ
موازٍ لعالم الباطن. نحن نعلم
أنَّ الاقتراب من الحسِّيّ يُطاوع
الشاعر في ابتناء عالم روحانيّ،
إذ تتخذ المحسوساتُ هالاتٍ
روحانيَّةً، فيصبح الحجر كآبة
الأبد، والنهر عنفوان الوجود
وتجدّده).
إن شاعرنا يغمرنا بزهو
بالفرح والحب، وأحيانا يعمد إلى
القاء أسئلته المحيرة عن الكون
والوجود ليترك المتلقي يذهب إلى
ابعد من النصوص، واستشهد بذلك
بقصيدته (رغبات):
(تريدُ الشَّمسُ أن تسهرَ الليلة
في نادي الكواكبِ والنجوم
لكنّها تخاف أن تتأخر
ولا تشرق غداً في موعدها المُحدّد.
يريدُ القمرُ أن يحلّقَ عالياً
ويخرج من مداره المرسوم
لكنّه يخاف أن يقعَ في الثقوبِ
السُود.
يريدُ العاشقُ أن يستحضرَ حبيبته
من غياهب النسيان
لكنّه يخاف حينَ تجيء،
أن يجيء معها الماضي
وأشباحه وسكاكينه المتوامضة وسطَ
الظلام.
يريدُ النهرُ أن يعودَ لأهله
لكنّه يخاف من اللصوص،
اللصوص الذين وقفوا له بالمرصاد
عند حدود الطبيعة.
يريدُ الشاعرُ أن يكتبَ قصيدته
الجديدة
لكنّه يخاف أن يكونَ ثمنها
كفّه التي لا تجيدُ إلّا المحبّة
ورأسه الذي يعيشُ بشغفٍ
عزلةَ العارفين).
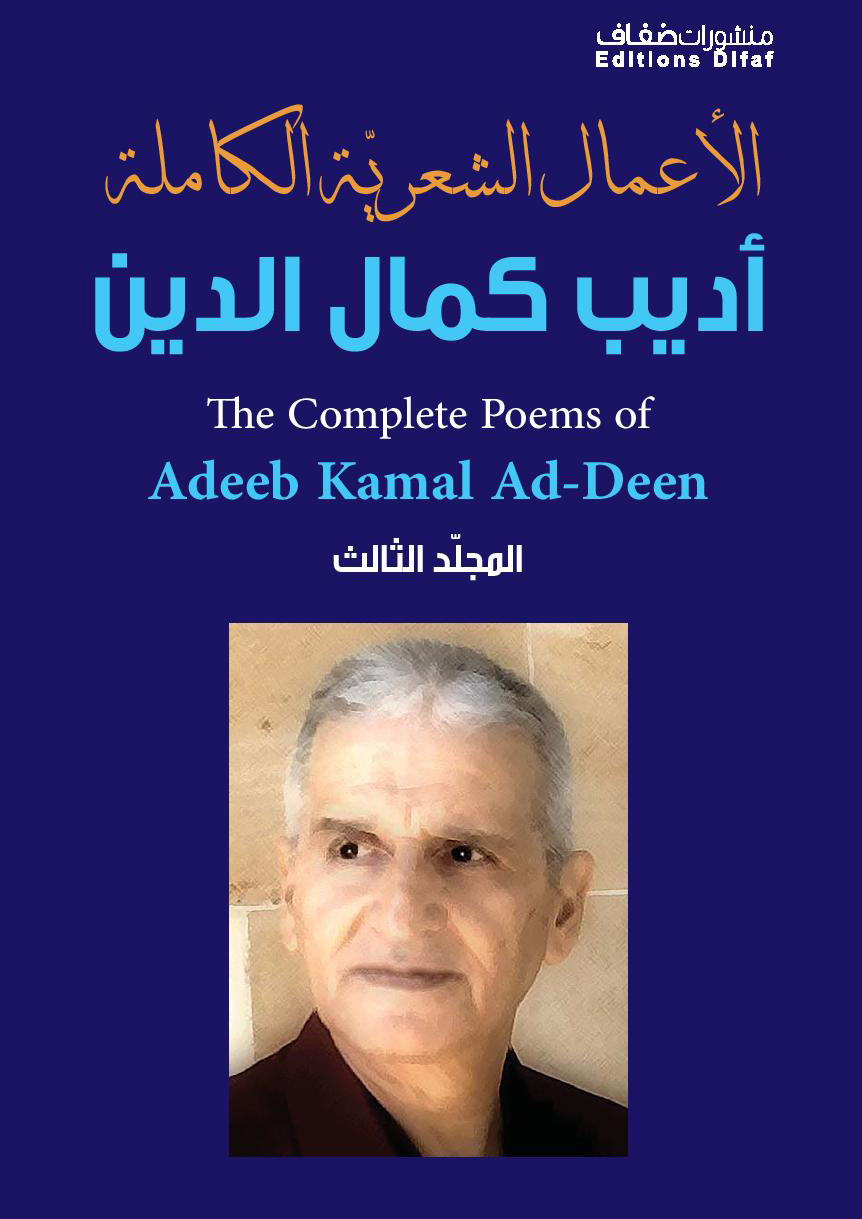
فهل كان شاعرنا الأديب يحاول أن
يوقظ النفس الراكدة لتستفيق
ولتفكر عما حولها على الرغم مما
يعتريها من ألم، وبما يعصرها من
غضب، علّها تتمحور نحو أفق جديد
ليتسع الاكوان كلها كما قال
الامام علي (ع) من قبل:
(وتحسبُ انك جرمُ صغير
......وفيكَ انطوى العالم
الاكبرُ)
فأين نقع نحن في هذا
العالم الأكبرالفسيح وفلواته
المتسعة؟
قال تعإلى في سورة
الذاريات: (وَالسَّمَاءَ
بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا
لَمُوسِعُونَ). فهل وجد
شاعرنا سرّ هذا الاتساع في الحرف
ليفتح عيوننا به على الآخر؟
وهل صار حرفه (كرسيّه الوثير
وكلماته قراطيس الألم ولمعان سيف
الروح البتّار الذي يشقّ عباءات
الرحيل وصهيل الليل في خلوات الشاعر)؟
على حد تعبير الكاتب والروائي
حميد المختار (جريدة الصباح
البغدادية 26 آذار 2017).
وهل كان للغربة الروحية
دور في توّهج أنفاسه الملتهبة؟
فاذا كان الإمام علي (ع) يصرّح
بأنّ (فقد الأحبّة غربة)، فهل كان
الشاعر كمال الدين يشير إلى ذلك
في حالتين،أولها الغربة الروحية،
وثانيهما الغربة الخارجية؟ وهي
ناتجة ولا شكّ عن المكابدة
الإنسانية التي أحسها في الوطن
كما في خارجه، فهكذا جاء الحرف
ليعبر عن هذه الغربة! وليضفي على
القصيدة إشراقة المعنى وتأويلها
الرمزي
الأمر الذي سيمدّه بآفاق
كبيرة موحية بإلهامات جديدة حين
يستدعي حروفها من تراثنا الثرّ،
ليوظفها في اطار عصري لتعلن عن
نفسها بتشكيلة جديدة. اذ نجد
الشاعر قد استغل التراث استغلالا
جيدا اذ كان يورد الكثير من
المعتقدات والآيات القرآنية
ليوظفها توظيفا جديدا، ولينير بها
قصائده. ففي قصيدة (وَصْف) التي
يستهل بها الشاعر أعماله الشعرية
الكاملة/ المجلّد الثالث،
نراه يستلهم التراث
القرآني حين يقول:
(سقطتْ دمعةُ الشاعرِ على الورقة،
فرأى فيها إخوةَ يُوسُف
وهم يمكرون ويكذبون،
ورأى دمَ الذئب
ورأى أباه شيخاً وحيداً يتمتم:
يا أسَفَى على يُوسُف، يا أسَفَى.
ثُمَّ نظرَ مرّة أخرى
فرأى نارَ إبراهيم،
ورأى صليبَ المسيح،
ورأى الموتى ينهضون،
والعميان يتشبّثون
ببعضهم، يصرخون.
ثُمَّ رأى موسى
يعبرُ بحراً من الرعبِ والموت
ورآه وهو يقولُ: ربّي.
فَيُقالُ له:
لنْ تَراني،
انظُرْ إلى الجَبَل
فإن استقرَّ مكانَه
فَسَوفَ تَرَاني).
وهكذا تتسلسل الأحداث في هذه
القصيدة:
(رأى عَاداً وثَمُود
ورأى أصحابَ الأخدود
ورأى صحارى محمّد وأصحابه عند بدر
ثُمَّ رأى رأسَ الحسين
يُحْمَلُ فوقَ الرماح،
فوقَ خيولِ الخوَنَة
لِيُنقَلَ بين مدن الكَفَرَة
الفَجَرَة).
وهكذا تتراءى لنا هذه
التراجيديات كلها وليصف لنا
الشاعر مشاهد الأنبياء والرسل
والرسالات كلها ليختصرها في دمعة
واحدة! ترافقها الأحزان كلها ليصل
بقصيدته تلك إلى ذروتها عند رأس
الحسين (ع) وهو يُحمل فوق
الرماح... فالشاعر ينظر إلى
الحروف ومنتهاها
ليطلع عليها بمنظار آخر فهي، وليس
هو، التي تشكي وتنوح (ودموع بهيئة
لؤلؤ وحروف/ وقصائد بكتْ واشتكتْ
وادّعتْ)
كما في قصيدة (الزائر
الأخير). فالناس لا يفهمون السرّ
الخفي الذي سيظل حبيساً في صدر
الشاعر اذ نجده حينما سلّم
القصيدة إلى الشرطي الذي ضربها
على رأسها بأخمص المسدس، فهذه
لغته الوحيدة التي يجيدها، حتى
نزفت القصيدة حروفا كثيرة ونقاطا
اكثر دون أن تعترف بسرّها
ومعناها! وهنا يضفي الشاعر
تجسيداً بشرياً ليصور لنا
الاضطهاد الذي يلاقيه الشاعر من
مجتمع لا يفقه معنى الحياة! حينما
حاول أن يسلّم القصيدة إلى
الحسناء ثم إلى الطفل وحتى النهر
إلى أن صارت القصيدة بيد الشرطي
الذي أوجعها ضربا فهذه لغته
الوحيدة التي يجيدها (السادية!).
أما في قصيدة (قليل من التراب)
فيلجأ الشاعر إلى نوعين من
الحركات اللونية، فإمّا التشابه
وإمّا التضاد، ففي التشابه نجد: (
القليل من العري عند البحر وفوق
السرير/ والقليل من صيحات مشجّعي
كرة القدم ومصارعة الثيران!
والقليل من دموع اللاجئين/
ومراكبهم الصدئة التي تغرق كل يوم
في محيطات الله). أما في حالة
التضاد في الإيقاع فنجده مُجسّدا
في (القليل من الليل والفجر،
والقليل من الأحلام والهلْوَسات
والكوابيس!) وفي النهاية سينقلب
كل شيء إلى تراب، ولا يبقى أخيرا
الّا قليل من التراب. وهكذا يقف
المتلقي مذهولا أمام قصيدة كهذه.
لذا فإنني أجد نفسي عاجزا في أن
أعّبر عنها بكلمات أو حروف!
ويصل
الشاعر إلى القمة في التصعيد في
نظرته إلى معاناة الإنسان
ومكابداته، ففي (قصيدتي الازليّة)
يصوّر لنا الشاعر أنه ركب في
سفينة نوح حتى اذا نزل جميع
الركاب لكنه وهو- المؤمن الضّال-
(وتركني في المركبِ دهراً فدهراً
حتّى إذا غيّبَ الموتُ نوحاً،
تحرّكَ المركب
تحرّكَ بي وحدي
لأواجه طوفانَ عمري
في موجٍ كالجبال،
أنا الذي لا أعرفُ الملاحةَ
والسباحة).
واذا كان أهل أور قد
اضرموا النار لإبراهيم، فإنهم
انتبهوا للشاعر واتهموه بأنه من
اتباعه:
(وإذ كانت النارُ على إبراهيم
برداً وسلاماً
فإنّها لم تكنْ لي
سوى نار من الألمِ والحقدِ
والحرمان
اشْتَعَلتْ،
ولم تزلْ تشتعل فيَّ
في كلّ يوم،
هكذا إلى يوم يُبعَثون!)
وهكذا حتى الأزل، فبداية الرواية
الألم ونهاية الرواية الألم ..ومن
هنا نجد أن الشاعر قد أوقف نزيف
قلبه على الحرف، متخطيا كل ما
يطرحه الشعراء من عناوين، في هذا
الوقت الذي تحوّل فيه الإنسان إلى
رجل الغاب على ضوء المعطيات
الجديدة والتقنيات الحديثة التي
بقدر ما حملت معها في فتح افاق
واسعة علمية واجتماعية ومعرفية لم
تكن معروفة من قبل لكنها ومن جانب
اخر صارت اشبه بحشرة (الارضة)
التي تنخر في كل شيء جميل وقيّم.
ومن هنا نجد الشاعر وهو يحاول أن
ينقلنا من الواقع المرئي إلى
الواقع اللامرئي كعملية انسلاخ
حياتي من هذا الواقع المر، فكأنه
يتخذ منه واحة في عز صحراء قاحلة
لا زرع فيها ولا ضرع، للتخلص من
حرها اللاهب وقيضها الحارق فيغرف
منها ويغتسل ما شاء له بعد عناء
وعطش صادٍ. وعلى حد تعبير الناقد
الأستاذ (صالح الطائي) اذ ينظر
اليه مثله: (كمثل الصائغ المبدع
يمكن أن يصنع حروفاً من ذهب
تتزيّن بها الجميلات، ولكن نادرا
ما تجد شاعراً يصنع حروفاً من سحر
تزيّن عقول الناس). (أديب كمال
الدين : حرف غرد في منفى/ جريدة
كل الأخبار 17 آذار 2016)
والذي يضيف أيضا (تصبح النقطة
بحرا، ويصبح البحر سفينة، وتصبح
النقطة وطنا، ويصبح الحرف سماءً،
وتصبح النقطة سلاما ، ويصبح الحرف
حمامة ، ويصبح الحرف عيناً.)
وسلاماً لك أيها
الشاعر المبحر في بحر
الحرف المتلاطم...
**********************************
الأعمال الشعرية الكاملة: المجلد
الثالث: شعر: أديب كمال الدين،
منشورات ضفاف، بيروت، لبنان 2018
|

